المجتمع المدني الجزائري بين التمكين والتعبئة الاستراتيجية
2025-07-08 21:15:00

<p>في ظرف وطني وإقليمي دقيق، يعيش فيه المجتمع المدني تحولات نوعية بين ضغط التحديات وانتظارات الدولة، جاء تنظيم كل من الجامعة الصيفية للمجتمع المدني ومهرجان المرأة الصحراوية... ذاكرة، هوية ونضال تحت إشراف المرصد الوطني للمجتمع المدني، ليؤكد أن الفعل الجمعوي في الجزائر لم يعد هامشيًا، بل بات جزءًا أصيلاً من الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمتين الجبهة الداخلية وبناء الدبلوماسية الشعبية الناعمة.</p> <p> </p> <p>أولاً: الجامعة الصيفية... تكوين الأدوار وإعادة هندسة الوظائف الجمعوية</p> <p> </p> <p>لقد مثلت الجامعة الصيفية، المنظمة عبر ثلاث محطات ساحلية، لحظة تأطيرية بامتياز لفواعل المجتمع المدني، بما حملته من تنوع في الفئات (جمعيات، مؤثرون، أساتذة جامعيون، إعلاميون...)، وتعدد في المضامين التكوينية والورشات التطبيقية.</p> <p> </p> <p>من التنشيط إلى التمكين:</p> <p> </p> <p>أظهرت هذه المبادرة أن الدولة انتقلت من التعامل مع الجمعيات كفاعل موسمي إلى التعويل عليها كركيزة في مواجهة تحديات السيادة، والمواطنة الرقمية، والوقاية من التهديدات الاجتماعية والثقافية.</p> <p> </p> <p>. التمكين هنا لم يكن فقط معرفيًا بل استراتيجيًا، بتوسيع مجالات الفعل المدني وربطه بالتحديات الكبرى للأمة.</p> <p> </p> <p>المجتمع المدني كفاعل في الأمن الثقافي:</p> <p> </p> <p>لقد تم الاشتغال بذكاء على موضوعات "الذاكرة الوطنية"، و"حروب الجيل الخامس"، و"تزييف التاريخ"، بما يجعل من المجتمع المدني حاجزًا رمزيًا في مواجهة الاختراقات السردية، لا سيما من قبل المنظومات المعادية التي تحاول تفكيك التماسك الوطني من الداخل.</p> <p> </p> <p>. المرأة والمشاركة الحقيقية:</p> <p> </p> <p>أحد أوجه القوة في هذه الجامعة هو التركيز على دور المرأة في التنمية وصنع القرار، ليس فقط كشعار بل كمحور للنقاش والتفكير الاستراتيجي، ما يرسخ منظورًا جديدًا للنوع الاجتماعي داخل الحركة الجمعوية الجزائرية.</p> <p> </p> <p>ثانيًا: مهرجان المرأة الصحراوية... حين تُصبح الثقافة وسيلة مرافعة جاء مهرجان "المرأة الصحراوية: ذاكرة، هوية ونضال"، في مستغانم، ليُظهر كيف يمكن للمجتمع المدني أن يتحول إلى أداة مرافعة ناعمة عن القضايا العادلة، في انسجام تام مع الثوابت السياسية للجزائر، وفي مقدمتها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.</p> <p> </p> <p>المرأة الصحراوية كنموذج صمود: لقد تم إبراز دور المرأة الصحراوية في مسار التحرر، وفي بناء مؤسسات الدولة الصحراوية، ليس من منطلق إنساني فقط، بل كفاعل سياسي وحقوقي يملك شرعية التاريخ وراهنية الخطاب. وهذا يُعد توظيفًا استراتيجيًا للهُوية في بناء سردية بديلة للخطاب المخزني المهيمن.</p> <p> </p> <p>الثقافة كأداة مقاومة: من خلال المعارض الفنية، الورشات الإعلامية، والمهرجانات الخطابية، تم توظيف الثقافة كجبهة ناعمة في الصراع، وإيصال رسالة إلى الرأي العام الجزائري بأن القضية الصحراوية ليست فقط مسؤولية الدولة، بل هي مسؤولية الوعي الجمعي أيضًا.</p> <p> </p> <p>الجبهة الداخلية الممتدة: إن إشراك المجتمع المدني الصحراوي إلى جانب الجزائري، وبمرافقة شعبية واسعة، يؤسس لما يمكن تسميته بـ"الجبهة المدنية المغاربية"، حيث تتوحد الشعوب حول قيم المقاومة، والعدالة، والحرية.</p> <p> </p> <p>ثالثًا: المرصد الوطني للمجتمع المدني... من الملاحظة إلى الفعل المؤسس إن ما يُحسب للمرصد الوطني للمجتمع المدني، تحت قيادة الدكتورة ابتسام حملاوي، هو قدرته على الانتقال من الدور الاستشاري إلى الدور التأطيري والتنسيقي، مع الالتزام بالرؤية الوطنية في بعدها الاستراتيجي.ث</p> <p> </p> <p>قد أصبحنا أمام مؤسسة وطنية تجمع بين: التأطير والتكوين التعبئة والمرافعة الوساطة بين الدولة والفاعلين المدنيين هذا التحول اعتقد أنه يعكس ثقة متزايدة من الدولة في نضج المجتمع المدني، ورغبة واضحة في خلق بيئة مدنية فاعلة، وآمنة، ومنتجة.</p> <p> </p> <p>ختامًا: من لحظة تنظيمية إلى مسار دائم المبادرتان ليستا مجرد حدثين مناسباتيين، بل هما علامتان فارقتان في هندسة جديدة للفعل المدني في الجزائر، وفتح لمسارات بديلة لتثبيت الانتماء، وتعزيز الجاهزية المجتمعية، في ظل عالم متحول وسياقات إقليمية مضطربة.</p> <p> </p> <p>كل الشكر والتقدير للسيدة ابتسام حملاوي، رئيسة المرصد، على هذا النفس الوطني العميق، وعلى قدرتها على تجسيد الانسجام بين الدولة والمجتمع ضمن منطق الشراكة والمواطنة.</p> <p> </p> <p>فعلًا، نحن أمام مجتمع مدني جديد... مدني في روحه، ووطني في التزامه، واستراتيجي في أدواته. توصيات راهنية لتعزيز أدوار المجتمع المدني:</p> <p>مأسسة المتابعة والتقييم بعد الفعاليات الكبرى: ضرورة إنشاء آليات تقييم دوري لمخرجات الجامعة الصيفية والمهرجانات الموضوعاتية، لضمان الاستمرارية وتحويل التعبئة الظرفية إلى تأثير طويل المدى، سواء عبر تقارير دورية، أو وحدات تتبع داخل المرصد. خلق شبكات فكرية – ميدانية بين الفاعلين المدنيين والجامعيين:</p> <p> </p> <p>تشجيع إقامة شبكات بحثية وتكوينية تضم أساتذة الجامعات وفاعلين جمعويين، تعمل على إنتاج معرفة تطبيقية حول التحديات المجتمعية وتدعم اتخاذ القرار الجمعوي بناء على بيانات دقيقة.</p> <p> </p> <p>تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مناطق الظل والجنوب الكبير: لضمان عدالة تمثيلية وفعلية، يُوصى بتوسيع الأنشطة التكوينية للمجتمع المدني نحو ولايات الجنوب والهضاب، ودمج الجمعيات الناشئة في مسارات التأطير والتمكين.</p> <p> </p> <p>إنشاء منصات وطنية للمرافعة الرقمية المدعومة علميًا: إطلاق منصات أو مجمعات محتوى رقمي توظف صناع المحتوى، بدعم أكاديمي وإشراف مؤسساتي، للدفاع عن القضايا الوطنية (مثل القضية الصحراوية، السيادة الغذائية، الذاكرة) باستخدام أدوات الميديا الحديثة. تشجيع البحث السوسيولوجي التطبيقي حول المجتمع المدني:</p> <p> </p> <p>إدراج مواضيع المجتمع المدني كأولويات الأمن الاجتماعي، والتنمية المستدامة، والهوية.</p> <p> </p> <p>ا.د ناجح مخلوف: أستاذ باحث في علم الاجتماع جامعة المسيلة ورئيس جمعية وطنية</p>
القمة الأمريكية الإفريقية لترامب... بين الغنم والغنيمة
2025-07-07 11:14:00

<h3><strong>في الفترة من 9 إلى 11 جويلية الجاري، يستقبل البيت الأبيض رؤساء ليبيريا، غينيا بيساو، السنغال، موريتانيا والغابون. فهل هي دعوة أم استدعاء؟ الحراك الدبلوماسي لدونالد ترامب في افريقيا يبدو في خطواته الأولى، لكنه لا يخلو من رسائل واضحة.</strong></h3> <p> </p> <p>القمة الإفريقية المصغّرة، التي ستُعقد قريبا في العاصمة الأمريكية واشنطن، تأتي في سياق تحضيرات إدارة ترامب لقمة إفريقية–أمريكية أوسع مقرر تنظيمها في سبتمبر المقبل. لكن الأجندة تتجاوز هذا الموعد، إذ تدلّ المؤشرات إلى رغبة أمريكية حثيثة في إعادة ترتيب التوازنات في النصف الجنوبي للقارة الإفريقية.</p> <p>وليس الأمر مجرّد نزوة جديدة للرئيس ترامب، يحاول فيها تقمّص شخصية بسمارك. فالتفاصيل المرتبطة بهذا اللقاء، الذي سيجمع ترامب بخمسة رؤساء أفارقة، تثير أكثر من علامة استفهام. من جهة، جاء إلغاء دعوة ساحل العاج في اللحظة الأخيرة متزامنًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية هناك. ويبدو أن واشنطن لا تفضّل دعم الرئيس الحسن واتارا، الذي يُنظر إليه على أنه أقرب إلى الأوروبيين منه إلى الأمريكيين، وذلك رغم نفوذه الدبلوماسي وحاجته للتاييد الامريكي . هذا التوجه ليس معزولًا عن سياق اللقاء، بل يتكرّر في أكثر من زاوية. فالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي دُعي أساسًا بصفته الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي (حتى فبراير الماضي)، يبدو أنه اختير للعب دور الوسيط أو الضامن لتوازن اللقاء، في مواجهة أي تضارب محتمل في المصالح بين الحاضرين.</p> <p>في المقابل، يتشارك بقية الضيوف – جوزيف بواكاي (ليبيريا)، باسيرو فاي (السنغال)، أومارو سيسوكو إمبالو (غينيا بيساو) وبريس أوليغي نغيما (الغابون) – في طموحات دبلوماسية واضحة. كما أن دبلوماسياتهم تحظى بعلاقات مستقرة مع أغلب دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتبدو منفتحة بشكل صريح على تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة، سواء للخروج من العباءة الأوروبية التقليدية، أو لتوجيه رسائل تذكير لكل من الصين وروسيا، المتّهمتين باهمال التزاماتهما في القارة منذ حوالي عامين. لكل من هذه الدول أجندته الخاصة، لكن الطموح المشترك حاضر.</p> <p>أما في الولايات المتحدة، فتتناول وسائل الإعلام عشرات السيناريوهات المحتملة. بين الضغط على النفوذ الصيني في غرب إفريقيا، ومكافحة شبكات تهريب المخدرات، وتعزيز اتفاق السلام الأخير بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، أو حتى مجرد استعراض دبلوماسي "على طريقة ترامب"، في كل الاحوال تسعى إدارة الرئيس الأمريكي إلى صرف الأنظار عن تدخلاتها الأخيرة في الشرق الأوسط (دعم إسرائيل ضد إيران) وأوروبا الشرقية (تخليها عن أوكرانيا).</p> <p>فهل يمثّل هذا اللقاء بداية لإعادة صياغة الأجندة الدبلوماسية لترامب؟ أم أن القارة الإفريقية تحوّلت ببساطة إلى ساحة انتصار سهلة المنال؟ بالنظر إلى حجم التحضير والزخم السياسي، قد تكون الإجابة أكثر تعقيدًا مما يبدو.</p> <p> </p> <p><strong>ما اكثر الخلّان حين تعدهم...</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p>يُعدّ دونالد ترامب أول رئيس أمريكي من الحزب الجمهوري ينظم قمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، رغم تاخرها. فخلال ولايته الأولى، لم يزر القارة سوى مرة واحدة. بل إن علاقاته مع إفريقيا كانت تتسم بنوع من الاحتقار، إلى درجة أنه وصف الدول الإفريقية بأنها «دول قذرة». حتى سفاح العراق جورج دبليو بوش قام بعشر زيارات رسمية إلى إفريقيا، وكان أكثر احترامًا في خطابه و اقل سملجة في سلوكه من ترامب. ورغم هذا الماضي، فإن ترامب اليوم يبني استراتيجيته الإفريقية على ما أسس له الرئيس الأمريكي السابق بايدن، الذي عيّن عددًا كبيرًا من السفراء في الدول التي تجاهلها ترامب خلال ولايته الاولى.</p> <p>بمعنى آخر: اهتمام ترامب بإفريقيا جنوب الصحراء جديد، ولا ينسجم كثيرًا مع نهجه المعروف.</p> <p>ومع ذلك، فإن الدفع نحو تموضع دبلوماسي جديد في القارة السوداء قد يدرّ أرباحًا كبيرة على البيت الأبيض. على سبيل المثال،اتفاق السلام حديث العهد بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والذي أُشرف عليه مباشرة من قبل ترامب، يبدو مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحقوق استخراج المعادن في المنطقة الحدودية بين الدولتين. ووفقًا لمعهد الولايات المتحدة للسلام (USIP)، فإن واشنطن «ستستثمر بشكل أساسي في الحزام الغني بالكوبالت والنحاس شرق الكونغو الديمقراطية». لكن ماذا يعني "الاستثمار" فعلًا؟ لا أحد يعلم. فالاتفاق غير منشور، وتفاصيله غامضة عمدًا. حتى توقيعه، الذي رُوّج له محليًا في الإعلام الأمريكي، مرّ دون اهتمام يُذكر على الصعيد الدولي.</p> <p>لذا، من غير المستبعد أن تُسفر القمة المقبلة مع القادة الأفارقة عن صفقات أخرى بذات الطابع الخفي، او بالأحرى المريب. أما القمة الإفريقية–الأمريكية في سبتمبر، فستكون – على الأرجح – مناسبة احتفاليّة "لعودة النفوذ الأمريكي في افريقيا".</p> <p>ولا بد من التذكير هنا بأن الصين منذ بدء سلسلة الانقلابات في منطقة الساحل، تخلّت عمليًا عن عدد من مشاريعها الكبرى في غرب إفريقيا. أما روسيا، ومنذ انشغالها بالحرب في أوكرانيا، فقد خفّف ممثلها "فاغنر" من حضوره في القارة. وقد أعلن هذا الأخير، مؤخرًا، انسحابه الكامل من مالي، مؤكدًا أنه "أنجز أهدافه" في "القضاء على الوجود الإرهابي". وهو تصريح لا يخلو من الشك لغرابة توقيته.</p> <p>في جميع الأحوال، يظل سياق هذا اللقاء – كمقدمة لما يُعرف بقمة إفريقيا–الولايات المتحدة – غامضًا، خاصة في ضوء المواقف الأمريكية الأخيرة تجاه القارة. فمنذ بداية ولايته الثانية، أوقف ترامب غالبية برامج المساعدات المقدّمة للدول الإفريقية، كما فرضت واشنطن حظرًا على دخول مواطني 12 دولة إفريقية إلى أراضيها. واليوم، لا تزال الإدارة الأمريكية تدرس إضافة 26 دولة إفريقية أخرى إلى قائمة حظر السفر المقبلة، التي سوف تضم 36 دولة.</p> <p> </p> <p><strong>...لكنهم في النائبات قليل</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p>تعكس سياسة شد الحبل هذه جانبًا مألوفًا من الدبلوماسية الخشنة التي ينتهجها دونالد ترامب. وقد أثارت قراراته في حظر السفر استياءً واسعًا لدى بعض الدول الإفريقية، على غرار تشاد، التي ردّت بإجراء مماثل ضد المواطنين الأمريكيين. في المقابل، فضّلت دول أخرى، مثل مالي وليبيا، عدم الخوض في هذا الملف. أما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد اعتبرت أن قرار حظر السفر الشامل لا يعدو كونه "إجراءً جديدًا مناهضًا للهجرة" من توقيع ترامب، بينما وصفت منظمة العفو الدولية هذه السياسات بأنها "تمييزية، عنصرية، وقاسية إلى أبعد حد".</p> <p>ومع ذلك، يبدو أن استراتيجية التخويف التي يعتمدها ترامب قد تؤتي أُكُلها. فالتحرك الدبلوماسي الأمريكي جرى ترتيبه بعناية. ومن الإنصاف القول إن ترامب، سواء في ملف أوكرانيا أو إيران، عرف دائمًا كيف يفاوض من موقع قوة. وإذا استمر في التزامه بنهجه المعتاد، فمن المرجح أن يطالب كل دولة مشاركة في القمة بتقديم تنازل واضح، مقابل تعويض رمزي أو محدود.</p> <p>فبالنسبة إلى الدول الحبيسة في غرب إفريقيا، قد تعرض واشنطن إقامة قواعد عسكرية جديدة مقابل تسهيلات تجارية. أما دول خليج غينيا، فلن يتردد ترامب في تحدي المصالح الفرنسية أو الأوروبية عمومًا في المنطقة، خاصة في ظل الشكوك المحيطة بمدى التزام الأوروبيين بتمويل حلف الناتو، كما تطالب به واشنطن. وبالنسبة إلى رؤساء الدول الذين سيحضرون الاجتماعات من 9 إلى 11 جويلية، فسيكون الأمر قبل كل شيء عرض قوة، يهدف إلى جسّ نبض "المزاج الإفريقي" قبل قمة قد تحمل في طياتها مفاجآت غير متوقعة.</p> <p>وهناك ملف آخر لا يقل أهمية بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية: اختبار ولاء ممثليها الدبلوماسيين في القارة، إلى جانب إعادة تثبيت الحضور السياسي الأمريكي في إفريقيا. فعلى مدى عقد من الزمن، اكتفى الأمريكيون بلعب دور الداعم الخلفي، تاركين الأوروبيين في واجهة الدفاع عن المصالح الجيوستراتيجية الغربية. والنتيجة كانت فشلًا ذريعًا: ففرنسا، التي كانت القوة العسكرية الغربية الأولى في الساحل الافريقي، طُردت من منطقة نفوذها، دولة تلو الأخرى، بفعل سلسلة من الانقلابات العسكرية. مالي، تشاد، غينيا، بوركينا فاسو، النيجر... كلها شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الخطاب والإجراءات المناهضة لفرنسا اثر تفعيل حكم العسكر.</p> <p>ومن الواضح أن الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى تحقيق هدفين في آن واحد: إعادة تثبيت الحضور الغربي في المنطقة، والاستفادة من المدّ المعادي لفرنسا لتحقيق بعض الأرباح الاقتصاديّة. ومع تراجع الحضور الروسي في بعض الدول، يبدو أن ترامب مصمم على اغتنام الفرصة. ويبقى السؤال: هل ستتكتّل الدول الإفريقية المشاركة في موقف موحّد؟ هل أنها، في لحظة وعي، قد تدرك أن ما يُقدَّم لها ليس أكثر من مطالب انتهازية في مرحلة قلّ فيها الحلفاء؟</p> <p> </p> <p>بقلم. نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي</p>
تونس، الجزائر، ليبيا: الموعد المحتوم ام الفرصة الضائعة؟
2025-06-30 09:35:00
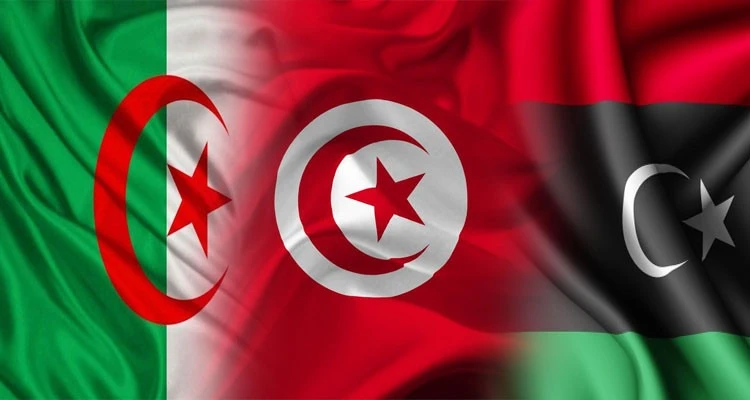
<h3><strong>بين التنافس التاريخي، والبطء الدبلوماسي، والجمود الاقتصادي، تجد بلدان المغرب الأوسط صعوبة في تحويل تقاربها الجغرافي إلى قوة مشتركة. المياه، الطاقة، البنية التحتية، الأمن: سواء تعلق الأمر بقطاعات حيوية للسلم الاجتماعي أو للتقدم الاقتصادي، تواجه الجزائر وتونس وليبيا تحديات مشتركة هائلة. وإن كانت المودة والتاريخ المشترك بين هذه الدول الثلاث يشجعان على التعاون بينها، فإن ما كان في السابق خيارًا، سيصبح قريبًا ضرورة لا مفر منها.</strong></h3> <p>تشترك تونس والجزائر وليبيا في أكثر من مجرد تاريخ مشترك. فعلى مرّ العقود، ورغم أن جميع مشاريع الوحدة الاقتصادية أو السياسية التي شملت باقي بلدان المغرب العربي قد اصطدمت بضرورات الاصطفاف الدبلوماسي، فقد بقيت العلاقة بين الدول الثلاث متسمة بقدر من الودّ والاحترام. وعرف الدعم المتبادل بينها فترات من المد والجزر، إلا أنه، وبالنظر إلى التحديات الوطنية الكبرى التي تواجه كلاً من ليبيا (البنية التحتية والأمن)، والجزائر (التجارة والمواد الأساسية)، وتونس (الطاقة والصناعة)، فإن التعاون الوثيق بات ضرورة مُلحّة.</p> <p>صحيح أن البلدان الثلاثة قد اعتمدت، كلٌّ على طريقته، على الدعم الخارجي لمواجهة الأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال، استطاعت ليبيا أن تخفّف من أزمة شُحّ المياه جزئيًا عبر مشروع النهر الصناعي العظيم (المعتمد على تكنلوجيا كوريّة). أما تونس، فرغم اعتمادها الكبير على استيراد الصناعات الثقيلة، فقد استثمرت في تحويل المنتجات الطاقية القادمة من الجارتين الجزائر وليبيا. بينما تعمل الجزائر، التي تسعى لفكّ العزلة عن تجارتها، على توسيع أسواقها الدولية والاستفادة من قربها الجغرافي من تونس وليبيا لتعزيز مشاريعها الإقليمية.</p> <p>جهود نافعة لكنها غير كافية، إذا ما أرادت الدول الثلاث أن تحمي نفسها من هيمنة العولمة. مع ذلك، بدأت بعض المشاريع الكبرى في التبلور. فهل تمثل هذه المبادرات فرصة لتعزيز الشراكة بين تونس والجزائر وليبيا؟ والأهم من ذلك: هل لا تزال مسألة تعميق التعاون بين الدول الثلاث خيارًا... أم أصبحت حتمية؟</p> <p> </p> <p><strong>تونس: مكاسب مهملة وإمكانات غير مستغلة</strong></p> <p> </p> <p>باعتبارها الأراضي الوسطى في أي اتحاد ثلاثي محتمل يضم الجزائر وليبيا، فإن تونس تملك الكثير لتكسبه من أي مبادرة ثلاثية. ورغم أن تونس بقيادة قيس سعيّد قد راكمت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية، فإنها ما تزال فعّالة حين يتعلّق الأمر بانسيابية العلاقات مع جيرانها. فالبلد المغاربي يركّز – ربما بحكم الضرورة؟ – على تصدير المنتجات الزراعية، والمشاريع المشتركة، واستيراد الغاز والنفط، وغير ذلك من الملفات الاستراتيجية المتصلة بالجزائر وليبيا.</p> <p>غير أن السلك الدبلوماسي التونسي لم يعرف منذ عام 2010 وزارة (او وزيرا) استقرت لأكثر من عامين. وهو ما أدى، بغضّ النظر عن أسبابه، إلى عرقلة المشاركة الفعالة لتونس في أي توسع ديبلوماسي في ليبيا أو الجزائر. ومع ذلك، لم تتوقف الأنشطة اليومية أو المعاملات الجارية. لكن مشاريع مثل إنشاء منطقة حرة جديدة (إذ تحتضن تونس بالفعل منطقتين حرتين للتبادل التجاري مع كل من جيرانها) تتطلّب مزيدًا من الجهود الدبلوماسية والترويج السياسي.</p> <p>فعلى سبيل المثال، بادر مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في عام 2019 إلى إطلاق مشروع ضخم لتكوين مطوري برمجيات في غانا، بهدف ضمان الاستقلالية الإنتاجية في مجال الحلول الصناعية. غير أن المشروع، الذي كان يُفترض أن يتحوّل إلى مركز تكنولوجي متكامل، استحوذت عليه لاحقًا دولة الإمارات العربية المتحدة وأطلقته فعليًا في غانا سنة 2024. مشروع كان من الممكن تنفيذه في تونس، بالاعتماد على الموارد المحلية، وتمويل ليبي او جزائري.</p> <p>خاصة وأننا نعلم أن شركتي النفط الوطنيتين، المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) في ليبيا، والمؤسسة الوطنية الجزائرية للحفر (ENAFOR)، قد استثمرتا مؤخرًا في برامج تدريب لمطوري البرمجيات. وقد استعانت كلتاهما بمدربين من روسيا وبريطانيا، كما أنشأتا بنيتهما التحتية السحابية ومراكز البيانات عبر مزودين أمريكيين.</p> <p>وإذا انطلقنا من مبدأ أن تونس تُعد رابع دولة إفريقية من حيث الاستثمار في تطوير الحلول الرقمية الصناعية، فإن خسارتها لأسواق الجوار تمثل، في أقل تقدير، فضيحة سياسية واقتصادية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فبالرغم من أن تونس تزخر بموارد بشرية ذات كفاءة عالية (مهندسون، يد عاملة متخصصة، إلخ...)، فإن هذه الكفاءات لم تعد حتى تفكّر في الهجرة نحو ليبيا أو الجزائر. وهو ما لم يكن الحال عليه في السابق. بل إن هذه النزعة الانعزالية قد امتدت لتشمل مجالات الاستيراد والتصدير، والزراعة، والتوأمة الجامعية، وحتى التعاون الأمني على الحدود المشتركة!</p> <p>قد يُفترض أن هذا الوضع حتمي. ومع ذلك، فإن تنظيمه عبر الهياكل القائمة لا يزال ممكنًا. ولا يمكن الادعاء بغياب الشركات الثنائية أو الإقليمية التي تمتد سلاسلها بين تونس والجزائر وليبيا. وبالنظر إلى خصوصيات كل من الجزائر وليبيا من الناحية الدبلوماسية، فإنهما لا تخضعان لأي ضغوط خارجية تمنعهما من قبول عروض مغرية قادمة من دولة جارة وصديقة. فشل دبلوماسي؟ ربما. ومع ذلك، فإن المعطيات الاقتصادية الإقليمية تحكم بإلغاء خيار التفرقة... لصالح المصلحة المشتركة</p> <p> </p> <p><strong>الجزائر: الخروج من فورة الاستثمار الصيني والتوجه نحو التعاون الإقليمي</strong></p> <p> </p> <p>ليس من المعتاد أن تبني الدولة الجزائرية قراراتها الاستراتيجية على الربح وحده. فعلى سبيل المثال، يُظهر كل من التعاون الأمني والعلمي مع روسيا، والانفتاح الواسع على السوق الصينية في مجال البنية التحتية خلال العقد الماضي، أن الجزائر تسعى قبل كل شيء إلى شراكات قائمة على مبدأ الربح المتبادل.</p> <p>فحتى في تعاملها مع القوى العالمية، تحرص الجزائر على أن تبقى ميزانيتها التجارية في وضع إيجابي بشكل عام — كما حدث، على سبيل المثال، عند إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية. والهدف، في جوهره، هو تحقيق توازن بين الخيارات الدبلوماسية واستدامة التجارة الدولية. ومن بين هذه الخيارات: قطع العلاقات مع المغرب. فالتوترات بين البلدين باتت مستعصية، والسياق أشبه بحرب باردة. أما مع تونس وليبيا، فقد حرصت الجزائر دائمًا على إبقاء العلاقات مستقرة وودية.</p> <p>وهذا يبرز بالأخص أن من مصلحة الجزائر نفسها أن تطوّر علاقاتها — الاقتصادية خصوصًا — مع كل من ليبيا وتونس. فالجزائر، من خلال علاقاتها المتينة مع الصين وسعيها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، تُدرج تلقائيًا ضمن مشروع "مبادرة الحزام والطريق" الصينية. ومنذ عام 2011، استثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية الجزائرية، مستخدمة تمويلها الخاص وأيديها العاملة — علمًا بأن عدد العمال الصينيين يكاد يعادل عدد المواطنين الليبيين والتونسيين المقيمين في الجزائر. شراكة ضرورية من الناحية العملية، لكنها لا تبدو قابلة للاستمرار على المدى الطويل، خصوصًا وأن المستثمرين الصينيين يُعرف عنهم النفور من أي اضطراب سياسي، مهما كان محدودًا.</p> <p>من جهة أخرى، فإن الثابت الوحيد في السياسة الجزائرية هو علاقتها الأخوية مع كل من تونس وليبيا، حيث يصل حجم التبادل التجاري مع كل منهما إلى ملياري دولار سنويًا! رقم ضخم، لكنه لا يعكس كامل الإمكانات المتاحة. ويُذكر أن الحدود الشرقية للجزائر شهدت العديد من الاضطرابات خلال العقد الماضي، مما أثّر على سلاسة التجارة غير الرسمية، وكذلك على نقل الموارد. ولهذا، قرر الرئيس تبون في أكتوبر الماضي رفع القيود المفروضة على استيراد المواد الخام الأساسية. علمًا بأن نسبة كبيرة من هذه المواد تأتي من أوروبا، ولكن أيضًا من تونس، أو تمر عبر تونس وليبيا.</p> <p>وتبقى قضيتان أساسيتان في صدارة أولويات الجزائر من جهة التبادل الإقليمي: الأولى هي تصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا، والذي يمرّ بجزء كبير منه عبر الأراضي التونسية، والثانية تتعلق ببيع الأسمدة الفوسفاتية، والتي تُعدّ ليبيا من أكبر زبائنها وموزّعيها في آنٍ معًا.</p> <p> </p> <p><strong>ليبيا: الحوار ممكن، لكن مع من؟</strong></p> <p> </p> <p>تُعدّ ليبيا، بالنسبة لتونس والجزائر، جارًا جيدًا رغم ما تمرّ به من أزمات. فمنذ نهاية الحرب الأهلية الليبية، وكذلك بعد انحسار أزمة كوفيد-19، أخذت العلاقات مع جيرانها في التحسّن المتواصل. فعلى الجانب التونسي، كانت استئناف المبادلات التجارية وإعادة فتح الحدود خطوات سريعة وفعالة. أما الجزائر، فما تزال حذرة نسبيًا في تعاطيها مع الملف الليبي.</p> <p>ويُعزى هذا الاختلاف إلى طبيعة الحدود المشتركة، التي تختلف جذريًا بين الجارين. وهي حدود تحوّلت، اليوم، إلى مناطق عسكرية تنتشر فيها الوحدات النظامية. والغريب أن هذا الوجود العسكري يساهم أيضًا في تأمين مرور السلع والمسافرين.</p> <p>لكن تبقى الدولة الليبية منقسمة، ما يجبر السلطات التونسية والجزائرية على تغيير مخاطبيها دوريًا. وهو ما يضفي طابعًا ساخرًا على العلاقات الإقليمية، تخففه أهمية السوق الليبية. سواء تعلّق الأمر بالمنتجات الزراعية أو الصناعية أو الثقيلة أو بنقل التكنولوجيا، فإن ليبيا تستورد بكثافة من جيرانها. مما يجعل من الجزائر وتونس في منافسة مباشرة، تارةً مع مصر، وتارةً أخرى مع أوروبا وتركيا. وفي نهاية المطاف، سواء تعلق الأمر بحكومة الغرب أو بسلطات الجيش الوطني الليبي في الشرق، تبقى آليات السوق قائمة. فالعرض الأفضل هو الذي يجد طريقه إلى السوق الليبية. لكن في ظل الانقسام السياسي، لا يمكن للدولة الليبية أن تضمن أمن الاستثمارات، ولا حتى سلامة الرعايا الجزائريين والتونسيين.</p> <p>تبدو كل من تونس والجزائر موحدتين في موقفهما المحايد تجاه الوضع في ليبيا. حياد يسمح باستمرار المبادلات التجارية، لكنه لا يضمن أي تطور جوهري في العلاقات. ويبدو أن هذا الوضع القائم يحظى بقبول ضمني من جيران الغرب. أما ليبيا، فهي بأمسّ الحاجة إلى التعاون مع تونس، خاصةً في ما يخص القطاع الطبي والمواد الأساسية. ومن الجانب الجزائري، فإن التعاون مع ليبيا في مجال المحروقات مشروط باستقرار الحدود المشتركة. إذ لا تستطيع شركة "سوناطراك" الجزائرية، ولا "بي بي" البريطانية، ولا "إيني" الإيطالية، أن تباشر أنشطتها في جبال الهقار (بالجزائر) أو في غات (بليبيا)، دون ضمانات واضحة من كلا الطرفين. فعديد القضايا الجيوستراتيجية في تلك المنطقة الصحراوية الغنية بالنفط، ترتكز على التفاهم المتبادل بين الأطراف المعنية.</p> <p>مهما كانت التطورات في طرابلس أو بنغازي أو سرت، فإن الجنوب الليبي يبدو بمنأى عن سيطرة الميليشيات الليبية أو الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة.</p> <p>"سلام نفطي" تضمنه على الأرجح القوات المسلحة الجزائرية، لكنه يعود بالنفع على الدول الثلاث، التي تجني بذلك سلامًا مشتركًا في قلب الصحراء.</p> <p> </p> <p><strong>تونس، الجزائر، ليبيا: لا يختار المرء عائلته</strong></p> <p> </p> <p>أمثلة كثيرة تُظهر أن البلدان الثلاثة، رغم اختلاف أزماتها الداخلية، تواجه تحديات مستقبلية متشابهة. فعلى العموم، يتقارب مؤشر التنمية البشرية بين تونس والجزائر وليبيا. وعلى الصعيد الاجتماعي، تخوض الشعوب الثلاثة معارك يومية متشابهة. أما الدول، فلها أولويات مختلفة... لكنها لا تستوجب بالضرورة هذا الاختلاف.</p> <p>أولاً، يسيطر هذا الثلاثي، بحكم الموقع الجغرافي، بشكل فعلي على ممر السويس – جبل طارق، الذي يُمثّل نحو ثلث التبادلات التجارية العالمية. إن الاستثمار الجاد في الموانئ العميقة (القائمة منها أو قيد الدراسة) يُعدّ خطوة حاسمة نحو إدماج تونس والجزائر وليبيا في التجارة العالمية. مشاريع ضخمة، نعم، لكن عائدها مضمون، وتمتد آثارها لتشمل قضايا حساسة أخرى كأمن المتوسط، والهجرة غير النظامية — وهي ورقة يمكن لعبها في مواجهة أوروبا — وكذلك تطوير البنية الرقمية. ويُشار هنا إلى مشروع "ميدوسا" للكابلات البحرية بالألياف البصرية، حيث تمر خمسة من ممراته السبعة عبر المياه الإقليمية للدول الثلاث.</p> <p>ثانيًا، ورغم تركيز الخطاب الرسمي في هذه الدول على ما يسمى "الثورة البيئية"، التي أثبتت محدوديتها من الناحية الاقتصادية، فإن الزراعة تبقى مجالًا أكثر واقعية. فالجزائر من بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الأسمدة، وتسعى باستمرار لفتح أسواق جديدة. أما ليبيا، وعلى عكس ما هو شائع، فتملك ثلاثين مليون هكتار من الأراضي الزراعية غير المستغلة. ويُرجع الخبراء السبب إلى نقص المياه وغياب الحوافز الحكومية. فليبيا، حفاظًا على توازن مواردها الجوفية، تستثمر بشكل كبير في تحلية المياه، بدلًا من تطوير الزراعة الميكانيكية — مع أن هذه الأخيرة، إذا ما وُظّفت فيها التقنيات الملائمة، قادرة على تلبية حاجات السوق المحلية، وتخفيض تكاليف الري، بل وحتى تقليص فاتورة الواردات.</p> <p>أما تونس، فتعاني بدورها من مشاكل تنظيمية في قطاع الزراعة، رغم كونه ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. إذ يواجه هذا القطاع تحديات عديدة: نقص البذور (نتيجة احتكار الشركات الأجنبية)، وانتشار زراعات غير مجدية من الناحية العلمية والاقتصادية (كالطماطم والبطيخ المخصصَين للتصدير)... وهي مشكلات، في الواقع، تُوجد حلولها بالفعل عبر الحدود. فمبادرات الزراعة المستدامة في تونس غالبًا ما تصطدم بارتفاع أسعار الأسمدة، أو تعقيد الإجراءات الإدارية.</p> <p>ثم إن استيراد المواد الخام — خاصةً من الدول الإفريقية — يتم في معظم الحالات بمبادرات من القطاع الخاص، سواء في الجزائر أو تونس أو ليبيا. في حين أن قوى إفريقية كإثيوبيا وغانا والسنغال، غالبًا ما تفاوض الصناعيين المغاربيين دون وسطاء. بل إن دول المغرب الأوسط نادرًا ما تتدخل في التجارة الإفريقية، سواء عبر ممثلياتها الدبلوماسية، أو عبر منظمة التجارة العالمية، أو حتى من خلال مؤسسات الاتحاد الإفريقي. تخلي غريب، لا سيما حين نعلم أن تونس والجزائر وليبيا تستورد بكثافة نفس المواد الخام (الخشب، النحاس، الألمنيوم، الكاكاو، البن، القطن...)، وغالبًا من أوروبا أو أمريكا اللاتينية، بأسعار مرتفعة.</p> <p>نعم، الحلول موجودة لتقليص كلفة الاستيراد، أو للاستثمار في التنمية المستدامة شمال القارة الإفريقية. لكن الأمر يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدول المعنية، على أن يكون تدخلًا دقيقًا وفعّالًا. والسؤال المطروح: هل توجد إرادة سياسية بحجم التحديات؟ لأن العائلة لا تُختار... لكن حين تشتدّ الأزمات، لا مفرّ من التكاتف في وجه العاصفة.</p> <p> </p> <p>نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي</p>
